قدّمت خمس دول أطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد مؤخرًا وثائق انسحاب، مستندةً إلى اعتبارات الأمن القومي والضرورة العسكرية. بينما اتخذت دولة أخرى واحدة على الأقل خطوات من أجل “تعليق” الاتفاقية (إيقاف الالتزامات مؤقتا). وتطرح هذه التطورات تساؤلات مهمة بشأن ما إذا كانت الألغام المضادة للأفراد لا تزال تحقق أية فائدة عسكرية في سياق النزاعات المعاصرة.
في هذا المنشور، يستعرض إريك تولفسن (Erik Tollefsen)، رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، وبيت إيفانز (Pete Evans)، رئيس وحدة حاملي السلاح والوقاية في اللجنة الدولية، هذه المسالة من زاوية ميدانية. يرى المؤلفان أن أوجه التطور في التكنولوجيا وواقع الحروب الحديثة قلصا إلى حد كبير من الأهمية العسكرية للألغام المضادة للأفراد،. ويشيران إلى استمرار آثارها الإنسانية الوخيمة. كما يعرضان مبررات تطرح عادة لاستخدام هذه الألغام، ومنها تأمين الحدود، و الفوائد المزعومة لما يسمى بالألغام الذكية (المزوّدة بخصائص استشعار أو تعطيل ذاتي)، وانخفاض الكلفة. ويبينان كيف تبدو هذه المبررات أقل إقناعا عند التدقيق. كما يوضحان أن تجدد الاهتمام بهذه الأسلحة قد يقوض التقدم المحرز تجاه الحد من استخدامها. ويدعو المؤلفان الدول إلى أن تستند في اتخاذ قراراتها إلى تقييمات دقيقة وشفافة للجدوى العسكرية الراهنة، مع مراعاة التزاماتها الإنسانية والقانونية. وفي بيئة أَمنية تتسم بوتيرة متسارعة من الابتكار، يَخلص المؤلفان إلى أن الألغام المضادة للأفراد، اليوم كما كان الحال عند اعتماد الاتفاقية قبل 30 عامًا، لا مكان لها في ميدان القتال الحديث. ويشيران إلى أهمية وأن إعادة تأكيد القاعدة المعيارية المناهضة لاستخدام تلك الأسلحة باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
أعاد قرار عدة دول مراجعة التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (معاهدة أوتاوا) الجدلَ حول دور هذه الألغام في الحروب الحديثة. وتعود جذور تلك النقاشات إلى نحو ثلاثين عامًا. فقد تفاوضت الدول آنذاك بشأن الاتفاقية. وقررت في نهاية المطاف حظر الألغام المضادة للأفراد. وانضمت إلى المعاهدة أكثر من ثمانين في المئة من الدول.
يعود هذا النقاش إلى الواجهة اليوم مجددًا، مع استمرار آثار إنسانية واسعة. إذ ارتفع عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار بنسبة 22 في المئة بين عامي 2022 و2023، وشكل المدنيون 84 في المئة من الضحايا المسجَّلين ممن عُرفت صفتهم. وكان أكثر من ثلثهم من الأطفال.[1] ومع ذلك يئل سؤال قائما: هل ما زالت هذه الأسلحة تحقق فائدة عسكرية في النزاعات المعاصرة؟
أدت الألغام المضادة للأفراد دورًا تكتيكيًا في تشكيل ساحات القتال في سالف الأيام. ولكن طبيعة النزاع تغيرت في السنوات الأخيرة. فالتقدم التكنولوجي، وتزايد دقة أساليب القتال، قلصا جدوى الأسلحة الثابتة (التي تُزرع أو تُثبت في مكانها). كما أن آثارها العشوائية (التي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين) قد تستمر طويلا بعد توقف القتال.
تاريخ الألغام المضادة للأفراد
محاولات تقييد حركة القوات المعادية قديمة قِدم الحرب نفسها. استخدمت الجيوش منذ فترة طويلة العوائق لتوجيه المهاجمين وتعزيز الدفاعات. ومع انتشار المتفجرات، تحولت هذه الوسائل من خنادق وأوتاد إلى عوائق متفجرة. وأصبحت قادرة على إصابة المقاتلين أو قتلهم.
وبحلول أوائل القرن العشرين، ظهرت ثلاث فئات رئيسية من الألغام. الأولى بحرية لمهاجمة السفن. والثانية مضادة للمركبات لاستخدامها ضد الدبابات والمركبات المدرعة. والثالثة مضادة للأفراد. والألغام المضادة للأفراد هي عبوات متفجرة صغيرة تضم فتائل حساسة تُفعَّل باقتراب شخص منها أو ملامسته لها.
وعلى خلاف الألغام المضادة للمركبات، التي تستهدف العتاد، تُصمم الألغام المضادة للأفراد لإصابة الأفراد أو قتلهم. وقد تخلّف آثارًا تمتد بعد انتهاء الأعمال العدائية. وقد تعمل بعض الأجهزة المتفجرة المرتجلة (عبوات ناسفة محلية الصنع) بالطريقة نفسها. وينطبق ذلك أيضا على بعض الألغام المضادة للمركبات المجهزة بآليات شديدة الحساسية. فتصبح قابلة للتفعيل عند تماس الشخص معها أو اقترابه منها.
مع أواخر القرن العشرين، برزت الآثار الإنسانية للألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع. واستجابت دول عدة لذلك عبر التفاوض على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997. واعتمادها.[2] وجاءت هذه الخطوة لأسباب متعددة، منها أن دولا وصفت هذه الأسلحة بأنها غير إنسانية. وشجعت منظمات إنسانية (الجهات الفاعلة الإنسانية) هذا المسار بعد توثيق الآثار ميدانيا. كما رأت عدة دول أن الفائدة العسكرية لهذه الألغام كانت محدودة للغاية.
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها. وتُلزم الدول بتدمير مخزوناتها القائمة. ولا يشمل هذا الحظر الألغام المضادة للمركبات. ويخضع تنظيمها للبروتوكول الثاني المعدل (بروتوكول ضمن اتفاقية الأسلحة التقليدية). كما ينطبق عليها الإطار الأوسع للقانون الدولي الإنساني. ويعد هذا الفرق جوهريًا، لأن النقاشات تخلط أحيانا بين الفئتين.
مع تجدد النقاشات بشأن هذه الاتفاقية، تسلط الخطوات التي اتخذتها بعض الدول مؤخرًا للانسحاب من الاتفاقية أو «تعليق» التزاماتها الضوء على التباين القائم بين الاعتبارات الإنسانية ومزاعم الجدوى العسكرية لهذه الألغام. ونظرًا لما هو موثق جيدًا من العواقب الإنسانية المترتبة على هذه الأسلحة، فقد حان الوقت لفحص مدى احتفاظها بأي جدوى عسكرية حقيقية في ساحات القتال في القرن الحادي والعشرين.
الأدوار العسكرية التاريخية للألغام المضادة للأفراد
على مر التاريخ، جرى استخدام حقول الألغام لإنشاء عوائق أو تعزيزها، وللتأثير في تحركات القوات المعادية في ميدان القتال. وفي إطار هذا المفهوم، كان يُنظر إلى الألغام المضادة للأفراد على أنها تؤدي جملة من الأدوار من بينها:
– حصر حركة القوات المعادية ومنعها من المناورة: استُخدمت الألغام المضادة للأفراد، بالاقتران مع الألغام المضادة للمركبات، لتوجيه القوات المعادية نحو مناطق يمكن الاشتباك فيها معها بواسطة المدفعية أو غيرها من الأسلحة، ولمنع الوصول إلى أراضٍ مهمة. وبذلك، كانت حقول الألغام تُستخدم كتدابير داعمة تُسهم في تشكيل نتائج الاشتباكات، من دون أن تكون عاملاً حاسمًا فيها.
– عرقلة عمليات الاختراق: عرقلت الألغام المضادة للأفراد إزالة حقول الألغام المضادة للمركبات، بما حافظ على فعاليتها وأدى إلى تأخير عمليات الاختراق، وهي وظيفة اكتسبت أهمية متزايدة مع بروز شن الحرب بالآليات، على نحو ما برز بوضوح في الحربين العالميتين.
– حماية القوات: استُخدمت الألغام المضادة للأفراد لتأمين قطاعات ضعيفة أو أطواق دفاعية، خاصة في محيط المواقع الحساسة أو في المناطق التي يتعذر رصدها بفعالية، الأمر الذي أتاح إعادة نشر القوات في جبهات أخرى. وقد أسهمت تلك الألغام كذلك في حماية البنية التحتية ومراكز الاحتجاز، من خلال ردع محاولات الاقتحام أو الهروب.
غير أن نشرها كان يستهلك الموارد بكثافة، وينطوي على مخاطر كبيرة لوقوع نيران صديقة، وتطلب زرعها بصورة آمنة توفر أفراد متخصصين، وإعداد خرائط دقيقة، ووضع علامات موثوقة عليها وتسييج حقولها. وفي الفترة بين أيار/مايو 1967 وتشرين الثاني/نوفمبر 1971، قُتل 55 جنديًا أستراليًا وأصيب أو شُوّه نحو 250 آخرين جراء ألغام M16 المضادة للأفراد في «حقل الألغام الحاجز» بطول 11 كم في مقاطعة فوك توي، جنوبي فيتنام، وهو حقل ألغام كانت القوات الأسترالية نفسها قد زرعته ثم قامت لاحقًا بإزالته، وشكّل حقل الألغام هذا وحده نحو 10 في المئة من مجموع ضحايا القوات الأسترالية في حرب فيتنام.
الأهمية المعاصرة للألغام المضادة للأفراد
بعد مضي أكثر من عقدين على دخول اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد حيز النفاذ، شهدت ديناميات ساحات القتال تطورًا سريعًا. ولقد غيّرت الحرب الحديثة، التي تتسم بالعمليات المتعددة المجالات والمناورة الجوية البرية والسرعة والدقة، الظروفَ التي كانت تُستخدَم فيها الألغام المضادة للأفراد في السابق، وتثير عدة تطورات في الوقت الراهن التساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة لا تزال تحتفظ بأي أهمية ميدانية:
– القدرات البديلة: تُستخدَم نظم الأسلحة الحديثة الموجهة بدقة – التي كانت في السابق مقتصرة على عدد قليل من الدول – على نطاق واسع حاليًا للتأثير في الحركة وتقييد الوصول إلى المناطق، ويمكن إعادة انتشار هذه النظم أو إعادة توجيهها تبعًا لتبدل الأوضاع، لمنع دخول المناطق بمرونة تفتقر إليها الأجهزة التي تُفعَّل بواسطة الضحية. وفي بعض السياقات، تُدمج العوائق الطبيعية أو العراقيل التي صنعها الإنسان مع نيران كابحة تُطلق عن بُعد أو نظم غير مأهولة بالأفراد لتحقيق تأثيرات مماثلة لمنع دخول المناطق، مع تجنب الجمود والآثار غير التمييزية التي تتسم بها الألغام المضادة للأفراد.
– المراقبة المستمرة: أسهمت التطورات في أجهزة الاستشعار والنظم الشبكية، ومنها المراقبة المحمولة جوًا، والرادارات الأرضية، وتكنولوجيات الطائرات بلا طيار، في الحد بدرجة كبيرة من النقاط العمياء في ساحات القتال. أسهمت هذه القدرات في تقليص القيمة التكتيكية للأسلحة الثابتة المستخدمة في منع دخول المناطق، مثل الألغام المضادة للأفراد. وعند إدماج المراقبة المستمرة بنظم الاستهداف الدقيقة، تتيح المراقبة المستمرة للقوات مراقبة المنطقة والتأثير فيها بصورة دينامية، بما يحقق أهداف السيطرة على المناطق من دون المخاطر الدائمة للتلوث الملازمة لحقول الألغام.
– تكنولوجيات الاختراق السريع: أسهمت أدوات التطهير الحديثة، مثل الشحنات الخطية المتفجرة، ونظم التطهير الميكانيكية عن بُعد، في تقليص الوقت والمخاطر المرتبطة بعمليات اختراق حقول الألغام. وتسهم هذه القدرات في إضعاف الدور التكتيكي التقليدي الذي كانت تضطلع به الألغام المضادة للأفراد في عرقلة تقدم القوات المعادية. ويجري في بعض السياقات اختبار تكنولوجيات ناشئة، ومنها منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد الألغام وتحييدها باستخدام المتفجرات المتشكلة التوجيهية أو عبوة التفجير. وفي حين لا يزال نشر هذه التكنولوجيات محدودًا ويطرح في حد ذاته تساؤلات إنسانية وقانونية، فإن هذه التطورات تُبرز تحولاً في تكتيكات الاختراق من شأنه أن يقوض بدرجة أكبر أي ميزة ميدانية متبقية تتيحها الألغام المضادة للأفراد.
– ركود التطوير: لم يشهد تصميم الألغام المضادة للأفراد، بما في ذلك الأنواع غير الدائمة، سوى قدر ضئيل من الابتكار منذ ثمانينيات القرن العشرين. وفي المقابل، شهدت تكنولوجيات عسكرية أخرى تطورًا متسارعًا على صعيد المدى والدقة ومستوى إدماجها في الشبكات. بل إن نظم الألغام المضادة للمركبات حققت تطورًا، ومثال على ذلك، جرى تطوير لغم PARM NextGen (DM 22) المضاد للمركبات من فئة خارج المسار ليكون مرنًا وقابلاً لإعادة الانتشار، بحيث لا يستلزم تأمينه بألغام مضادة للأفراد تؤدي دور «الحراسة»، وذلك بحكم أسلوب نشره واستخدامه. ويبرز هذا التباين عدم جدوى الألغام المضادة للأفراد، حتى في سياق عمليات الألغام المضادة للمركبات.
الدروس الميدانية المستفادة من الحالة الأوكرانية
لا تقدم التحليلات الحديثة الصادرة عن وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي ومؤسسة بحوث الدفاع النرويجية (FFI)، التي تغطي الأيام الـ 1,000 الأولى من النزاع المسلح الدولي بين روسيا وأوكرانيا، أي أدلة جوهرية على أن الألغام المضادة للأفراد قد حققت ميزة عسكرية يمكن قياسها. بل انصب الاهتمام على التكيف السريع وإدماج نظم أسلحة جديدة، جرى تطوير بعضها ونشرها ميدانيًا في غضون أسابيع.عندما يُشار إلى استخدام الألغام، نادرًا ما تميّز التقارير بين الألغام المضادة للمركبات والألغام المضادة للأفراد. وتختلف الألغام المضادة للمركبات عن الألغام المضادة للأفراد من حيث التصميم وآليات التفعيل، حيث تُفعَّل استجابةً لحركة مركبة أو اقترابها، وليس بوجود شخص أو اقترابه أو ملامسته. ولا تزال هذه الألغام خاضعة للتنظيم بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنه البروتوكول الثاني المعدل الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ولا تخضع للحظر القاطع نفسه المفروض على الألغام المضادة للأفراد.شكّل الاستخدام واسع النطاق للطائرات بلا طيار سمة مميزة لهذا النزاع وغيره من النزاعات التي اندلعت مؤخرا، إذ أعاد تشكيل تخطيط العمليات في ساحات القتال وتنفيذها. وانتشر حاليًا استخدام الطائرات بلا طيار لأغراض المراقبة والاستحواذ على الأهداف وتصحيح الضربات النارية، فضلاً عن استخدامها لتوجيه الذخائر إلى أهداف ذات قيمة عالية أو تتطلب استجابة سريعة زمنيًا.وتعمل هذه الطائرات أيضًا كذخائر حائمة أو كنظم هجوم أحادية الاتجاه، وتُعطل المناورة بفعل كثافتها واستمراريتها وقدرتها على التكيف. تفيد تحليلات هذا النزاع بأن الطائرات بلا طيار باتت مسؤولة عن نسبة كبيرة من خسائر المركبات ومن الضحايا في صفوف القوات في أوكرانيا.[3]بعيدًا عن أدوارها التكتيكية، أدى الوجود الدائم للطائرات بلا طيار إلى ضغوط نفسية جديدة على من يعيشون أو يقاتلون في مناطق تحلِّق فوقها.[4] وعلى غرار ما كان عليه الحال في السابق مع الألغام المضادة للأفراد، حين كان الخوف في حد ذاته يُعد أثرا تكتيكيًا، تتواتر تقارير بأن الطائرات بلا طيار – مصحوبة في الغالب بنيران غير مباشرة – تُحدِث شعورًا مشابهًا بالتعرض للخطر وعدم التيقن، ولكن على نطاق أوسع وباستمرارية ممتدة.يبرهن ذلك على أن أوجه التقدم التكنولوجي لا تفضي حتمًا إلى الحد من المعاناة الإنسانية، بل قد تقتصر على تغيير صورة تلك المعاناة لا أكثر. ويُعد استيعاب طبيعة هذه الأضرار المستحدثة أمرًا أساسيًا لضمان أن تظل الأسلحة والأساليب الجديدة والناشئة لشن الحرب متسقة مع القانون الدولي الإنساني.أدت فعالية نظم الدفاع الجوي الحديثة إلى تقليص جدوى المناورة الجوية وتقديم الإسناد الناري من الجو، مما دفع أطراف القتال إلى تكثيف الاعتماد على المدفعية التقليدية، فضلاً عن الطائرات بلا طيار والصواريخ، حيث تشير التقارير إلى أن آثارها في ميدان القتال أشد من آثار استخدام الألغام الأرضية.وفي سياقات أخرى، تُشكل قدرة القوات على التنقل بواسطة المروحيات أو غيرها من المنصات نمطًا من المناورة يمتنع تمامًا على الألغام المضادة للأفراد التصدي له، بينما تمتلك التركيبات القائمة على أجهزة الاستشعار والهجمات الدقيقة القدرة على التصدي لها النمط.
كيف أدت الحرب المعاصرة إلى فقدان الألغام المضادة للأفراد جدواها
لقد تغير المشهد الميداني للحرب تغيرًا جذريًا، فلم تعد المنفعة التقليدية التي كانت تقدمها الألغام المضادة للأفراد ذات أهمية تُذكر اليوم. ومع ازدياد سرعة النزاعات، وترابطها، واعتمادها المتزايد على تكنولوجيات الدقة والاستشعار، لم تعد الأسلحة الثابتة، التي تتسم بعشوائية أثرها ويصعب التحكم فيها، تقدم ميزة عسكرية يعتمد عليها. وأمام التدقيق والفحص لا تصمد الادعاءات بضرورة الألغام لتأمين الحدود، أو أن النماذج «الذكية» أو غير الدائمة منها تحد من الضرر الإنساني، أو أنها تتيح خيارًا دفاعيًا منخفض الكلفة، عند تقييمها في ضوء الواقع الميداني الحديث.
تتناول الأقسام الثلاثة الآتية بعض الأسباب التي أدت إلى تقويض المبررات الراسخة لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، وهي: القيود المفروضة على دور الألغام في الدفاع عن الحدود والأراضي، واستمرار عدم موثوقية ما يسمى بالألغام «الذكية»، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الألغام والأسلحة المعاصرة الأكثر قدرة على التعديل.
اعتبارات المناطق وأمن الحدود
بررت بعض الدول استمرار استخدامها الألغام المضادة للأفراد استنادًا إلى تأمين الحدود. غير أن الألغام، على اختلاف أنواعها، تتسم بطابع جامد بطبيعتها ولا يمكنها التكيف مع أنماط الحركة المتغيرة أو تطوّر الأوضاع الميدانية. وتتقلص فعاليتها بدرجة أكبر في الأراضي الوعرة، مثل المستنقعات أو ضفاف الأنهار أو المناطق المعرضة لتساقط الثلوج والفيضانات، حيث يمكن للظروف البيئية أن تؤدي إلى انجراف الألغام أو تعطلها أو التسبب في تلوث غير مقصود.
تُظهر الخبرات الحديثة المكتسبة من استخدام النظم القائمة على أجهزة الاستشعار، بما في ذلك في المناطق المغطاة بالثلوج الواقعة شمال خط العرض 60، أن تقنيات معينة لمراقبة الحدود يمكن أن تعمل طوال العام وتتكيف مع الظروف المتغيرة. وبخلاف الألغام المضادة للأفراد، يمكن لهذه الوسائل أن تخدم أغراضًا أوسع، من قبيل رصد حالات عبور الحدود أو التسلل غير المصرح بهما والتصدي لها، وقد تستتبع تدخلاً من جانب أجهزة إنفاذ القانون عند الاقتضاء.
في كثير من السياقات، تتيح البيئة الطبيعية في المناطق الحدودية بالفعل مزايا دفاعية كبيرة. فالمستنقعات والمناطق الرطبة تعوق العمليات الهجومية لكل من قوات المشاة والآليات، كما تحد الأرض اللينة المغمورة بالمياه من القدرة على الحركة خلال معظم أوقات السنة، في حين تتيح التضاريس المستوية قدرًا ضئيلاً من الغطاء الطبيعي. فعند التعرض لإطلاق النار، نادرًا ما يكون حفر تحصينات دفاعية في مثل هذه التضاريس أمرًا ممكنًا. على مر التاريخ، استُخدمت البيئة الطبيعية لتعزيز التحصينات الدفاعية، ويبدو في بعض السياقات أن هذا الأسلوب قد استعاد أهميته.
الألغام المضادة للأفراد غير الدائمة
رأى بعض الدول ومحللو الشؤون الدفاعية أن الألغام المضادة للأفراد غير الدائمة أو «الذكية» يمكن أن تحد من الضرر الإنساني مقارنة بالأنواع التقليدية من تلك الألغام، ولكن الأدلة المتاحة لا تؤيد هذا الادعاء.
تُصمم هذه الألغام لتدمير أو تعطيل نفسها ذاتيًا بعد فترة زمنية محددة، غير أن آلياتها غير موثوقة. ومن منظور إنساني، فإن ما يسمى بالألغام غير الدائمة لا هي «آمنة» ولا هي «ذكية»، إذ إنها، عند إخفاقها، تظل نشطة ولا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومن ثم يكون لها آثار عشوائية.
يُعد لغم PFM-1S أحد أكثر الأمثلة توثيقًا على الألغام ذاتية التدمير. أظهرت الدراسات التقنية أن آليات التدمير الذاتي فيه غير موثوقة وقد تترك الألغام في حالة حساسة.[5] وبوجه عام، يُرجَّح أن تتجاوز معدلات الإخفاق في ساحة القتال تلك التي تُسجَّل أثناء الاختبارات، كما أكدت ذلك مراجعات رسمية سابقة، [6] ويمكن أن تتراجع الموثوقية أكثر بمرور الزمن أو تدهور البطاريات أو التعرض للعوامل البيئية.
يُعد لغم ذخيرة المدفعية لمنع الوصول إلى المناطق (ADAM) لغمًا مضاد للأفراد من عيار 155 ملم تطلقه المدفعية وقد جرى تطويره في ثمانينيات القرن الماضي، باستخدام صمام يعمل بالبطارية لتفعيل التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة.[7] في حين تتوفر بيانات محدودة من المصادر المفتوحة بشأن موثوقيته، فإن نسبة من حالات الإخفاق ولو كانت ضئيلة يمكن أن تسفر عن تلوث بعيد الأمد. ولأغراض التطهير، يجب التعامل مع جميع الألغام المضادة للأفراد بوصفها مواد خطيرة ويتعين إزالتها، بصرف النظر عن العمر الزمني المقصود لها.
من منظور ميداني، يخلق هذا الافتقار إلى الموثوقية حالة من عدم اليقين لدى القادة. فإذا تعذر عليهم تحديد أي الألغام قد دمر ذاته أو عطّل نفسه ذاتيًا، فلن يكون بمقدورهم التنبؤ بالأماكن التي لا يزال الخطر قائمًا فيها. وتؤدي هذه الحالة من عدم القدرة على التنبؤ إلى تعقيد القيادة والسيطرة، وإبطاء أعمال التطهير بعد العمليات، وتعريض كل من الأفراد العسكريين والمدنيين لمخاطر متزايدة.
الألغام غير الدائمة ليست ابتكارًا جديدًا، فقد شهدت مفاوضات عام 1997 المتعلقة باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد نقاشًا موسعًا بشأن هذه الأنواع من الألغام، وتم إدراجها عن قصد ضمن نطاق الحظر الكامل الذي تفرضه الاتفاقية على جميع الألغام المضادة للأفراد التي «تُفعلها الضحية». والاعتقاد بأن الألغام المضادة للأفراد لا تزال خيارًا منخفض التكلفة لتحقيق غايات عسكرية هو اعتقاد في غير محله.
التكاليف المترتبة على استخدامها
قديمًا كان ينظر إلى الألغام المضادة للأفراد على أنها وسائل دفاعية منخفضة التكلفة، ولم يعد هذا الافتراض صحيحًا في الوقت الراهن. لم يعد قائمًا سوى عدد محدود من خطوط الإنتاج، بينما تخضع إجراءات الشراء والنقل والتخزين لأطر تنظيمية مشددة. وعند احتساب التكاليف الشاملة على امتداد دورة حياة هذه الألغام، بما في ذلك تكاليف التطهير في مرحلة ما بعد النزاع، يتضح أن التكلفة الإجمالية تفوق بكثير تكلفة الإنتاج في بدايتها.
إن تصور أن الألغام المضادة للأفراد منخفضة التكلفة يتناقض مع تكاليف نظم أخرى متاحة على نطاق واسع، وإن كانت المقارنة المباشرة بينهما غير قائمة. ويُظهر تقرير صادر عن حكومة الولايات المتحدة[8] يعود إلى عام 1985 أن ذخائر المدفعية من عيار 155 مم من طرازي ADAM M69 وM72، التي يحتوي كل منها على ألغام مضادة للأفراد، كان سعر الواحدة منها في ذلك الوقت 4490 دولارًا أمريكيًا.
وبعد تصحيح القيمة لمراعاة التضخم وتحديثها إلى قيم عام 2025، تبلغ التكلفة 13500 دولار أمريكي للوحدة الواحدة. ويشير التقرير نفسه أيضًا إلى مشكلات تتعلق بالذخائر التي لم تنفجر وبموثوقية المخزون. وبالمقارنة، تتوفر نظم مراقبة تجارية بسعر يقارب 2000 دولار أمريكي. وعند الموازنة بين الفعالية وقابلية التكيف والتكلفة، من غير المرجح أن ينظر المستخدمون المحتملون إلى الألغام المضادة للأفراد على أنها خيار اقتصادي.
تغفل المزاعم التي ترى في الألغام وسيلة مجدية من حيث التكلفة لتأمين الأراضي ما يترتب عليها من تكاليف شاملة، فضلًا عن محدودية الجدوى التكتيكية للأسلحة الثابتة في سياق العمليات العسكرية المعاصرة. ويتداعى أيضًا التصور القائل بانخفاض التكلفة عند النظر في ما يسمى بالألغام «الذكية»، إذ يترتب على إدخال نظم التدمير الذاتي أو التعطيل الذاتي ارتفاع ملموس في تكاليف الإنتاج والصيانة، دون أن تُظهر الأدلة المتاحة تحسنًا يعتد به في مستوى الموثوقية أو انخفاضًا فعليًا في الأضرار والمخاطر الإنسانية.
لم ينبغي الاستغناء عن الألغام المضادة للأفراد؟
لقد تغيّرت طبيعة الحرب تغيرًا جذريًا منذ ظهور الألغام المضادة للأفراد لأول مرة. يعتمد ميدان القتال المعاصر على الدقة والحركية وتكامل المجالات، وهي سمات تتعارض تعارضًا جوهريًا مع الأجهزة الثابتة وغير المرنة التي تلوث الأرض لفترة طويلة بعد زوال أي ميزة عسكرية. وحتى عند تقييم الألغام المضادة للأفراد حصرًا على أسس ميدانية أو اقتصادية، فقد تجاوزتها تكنولوجيات تحقق أثرًا أكبر بتكاليف أقل على المدى البعيد، ما يجعل تبرير استمرار استخدامها أكثر صعوبة.
من المرجح أن تكون ميادين القتال في المستقبل أكثر تعقيدًا وترابطًا وأتمتة، وتتشكل بأجهزة استشعار متقدمة، ونظم روبوتية، وأسلحة موجهة بدقة تعمل عبر البر والبحر والجو. وفي مثل هذه البيئة، تتلاشى بسرعة السيناريوهات القليلة التي لا تزال بعض الدول تدعي فيها أن الألغام المضادة للأفراد تحتفظ بقيمة تكتيكية.
كما تتسارع وتيرة البحث والتطوير في مجالات مثل الاستشعار، والضربات الدقيقة، والمراقبة الشبكية، في حين لا يكاد يوجَّه أي ابتكار نحو الألغام المضادة للأفراد، وهو ما يعكس تراجع قيمتها العسكرية مقارنة بنظم أكثر مرونة وقابلية للتوسع والاستجابة. توفر القدرات الحديثة لمنع الوصول/لمنع دخول المناطق— التي تتراوح من المدفعية الموجهة بدقة بعيدة المدى إلى قدرات الاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع (ISTAR) المعززة بالطائرات بدون طيار، بدائل أكثر قابلية للتكيف وأكثر فعالية من الأجهزة الثابتة المُفعَّلة بواسطة الضحية.
في مواجهة هذا التحول التكنولوجي، تبرز الكلفة الإنسانية الدائمة للألغام المضادة للأفراد. ولا يزال التلوث بالألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات يشكل عائقًا أمام العودة الآمنة وإعادة الإعمار والتنمية حتى بعد مرور عقود على انتهاء النزاعات، إذ أن هناك مناطق واسعة في البوسنة ظلت متضررة. بعد نحو ثلاثين عامًا من انتهاء الحرب، من شأن إعادة إدخال هذه الأسلحة أن تمثل خطوة مقلقة إلى الوراء.
ومع توثيق آثارها العشوائية توثيقًا جيدًا، يعتبرها العديد من الخبراء القانونيين غير قادرة بطبيعتها على التمييز، وهو شرط أساسي من شروط القانون الدولي الإنساني الذي تقوم عليه اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. وكما أشارت رئيسة اللجنة الدولية، فإن القانون الدولي الإنساني وُضع من أجل أحلك لحظات الحرب، عندما يكون الناس أكثر عرضة للخطر، ويُعد الحفاظ على القاعدة الراسخة المناهضة للألغام المضادة للأفراد أمرًا أساسيًا لتحقيق هذا الغرض.
في وقت تُشكّك بعض الدول في التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، يصبح من الضروري إعادة تأكيد القواعد التي تحمي المدنيين وتوجّه عملية اتخاذ القرار العسكري المسؤول، ويتعين أن يحل التحليل القائم على الأدلة، المستند إلى الواقع الميداني والتقدم التكنولوجي والقانون الدولي الإنساني، محل الافتراضات المتعلقة باستمرار جدوى هذه النظم المتقادمة.
تشجع «اللجنة الدولية» الدول على الاستفادة من خبراتها الوطنية في مجال البحث والتطوير الدفاعي لإجراء تقييمات صارمة وشفافة بشأن ما إذا كانت للألغام المضادة للأفراد أي أهمية عسكرية عند موازنتها بآثارها الإنسانية والتزاماتها القانونية. ومن شأن هذا التحليل أن يساعد على ضمان بقاء القرارات المتخذة باسم الأمن الوطني مرتكزة إلى الأدلة، وأن تصون روح الاتفاقية وغرضها، وأن ترفض الوعد الزائف بتحقيق الأمن من خلال الاستثناءات في زمن الحرب.
نشر هذا المقال بالإنكليزية على مدونة القانون الإنساني والسياسات
المراجع
[1] تقرير مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية لعام 2024، بيانات عن الضحايا (للفترة من 2022 إلى 2023).
[2] اعتُمدت اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (المعروفة عادة باسم اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد أو معاهدة أوتاوا) في 18 أيلول/سبتمبر 1997، وفُتحت للتوقيع في أوتاوا في 3-4 كانون الأول/ديسمبر 1997. ودخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999.
[3] بحسب ما أوردته مجلة فورين أفيرز، تتحمل الطائرات بلا طيار مسؤولية عن نحو 90% من تدمير الآليات المدرعة في النزاعات المعاصرة، ونحو 80% من الخسائر البشرية في صفوف القوات.
Schmidt, E and Grant, G, The Dawn of Automated Warfare, Foreign Affairs, 12 Aug 2025. The Dawn of Automated Warfare: Artificial Intelligence Will Be the Key to Victory in Ukraine—and Elsewhere
[4] See “Remote Warfare with Intimate Consequences: Psychological Stress in Service Member and Veteran Remotely-Piloted Aircraft (RPA) Personnel,” Journal of Military and Veterans’ Health 31, no. 2 (2025), https://www.mentalhealthjournal.org/articles/remote-warfare-with-intimate-consequences-psychological-stress-in-service-member-and-veteran-remotely-piloted-aircraft-rpa-personnel.html ; and Human Rights Watch, Hunted From Above: Russia’s Use of Drones to Attack Civilians in Kherson, Ukraine (3 June 2025), https://www.hrw.org/report/2025/06/03/hunted-from-above/russias-use-of-drones-to-attack-civilians-in-kherson-ukraine
[5] مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD)، ودليل الذخائر المتفجرة لأوكرانيا (الطبعة الثالثة، 2025).
[6] مكتب مساءلة الحكومة في الولايات المتحدة، “العمليات العسكرية: معلومات عن استخدام الولايات المتحدة للألغام الأرضية في حرب الخليج (2002)”، مع الإشارة إلى أن معدلات الإخفاق الميداني للألغام ذاتية التدمير كانت أعلى بكثير مما كان متوقعًا في الاختبارات. متاح على: https://www.gao.gov/products/gao-02-1003
[7] مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD)، ودليل الذخائر المتفجرة لأوكرانيا (الطبعة الثالثة، 2025).
[8] NSIAD-85-12 Results of GAO’s Review of DOD’s Fiscal Year 1985 Ammunition Procurement and Production Base Programs (page 14)



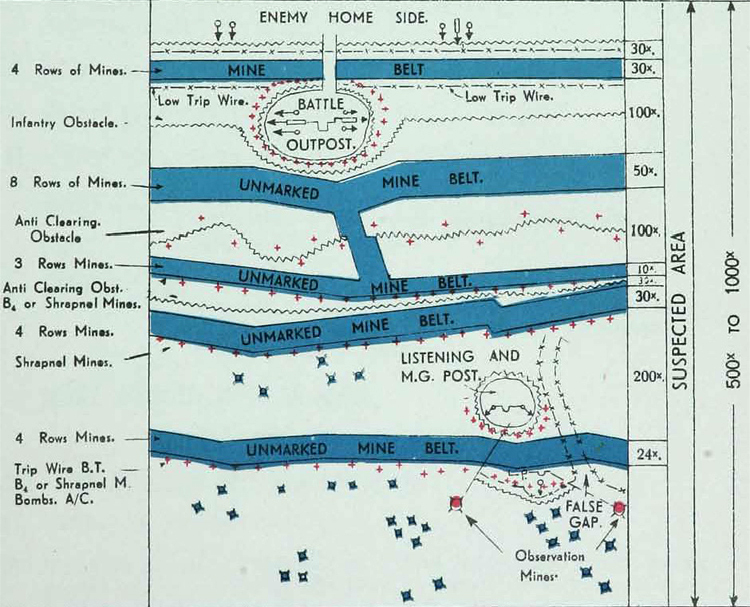


تعليقات