في السلم …الأبناء يشيعون الآباء
وفي الحرب …الآباء يشيعون الأبناء
بإيجاز درامي بارع ومكثف، يلخص ذلك المقطع الشعري للشاعر الإسباني لوركا قسوة ومحنة وجور الحرب، أينما حلت، وفي أي زمان من جحود وجنون هذا العالم المترامي بشساعة الموت وبشاعة فحواه. أخرج متسللا من خرم إبرة هذا المدخل الذي كنت- طوال عسكريتي الإلزامية – أردده مع نفسي وأهمسه يتسربل أمامي كشريط سينمائي متكاسل ببطء (سلوموشن) مصحوبا بعزف موسيقى جنائزية ينوء بثقل ما جاءت به، وما تجود، آفات الحرب من مفارقات ومفاجآت جميع مشتقات الموت.
ماذا يفعل شاعر مثلي، ممن عايش متواليات حروب ثلاث ومدججات حصارات وكوارث إنسانية وحماقات سياسة تغافلت عنها ضمائر العالم المتحضر، غير التقاط حبات الخوف بمنقار الحيطة والحذر والتوجس وحبس أنفاس ما يرتجف له القلب وما تشمئزه العين ويتقيأ فيه العقل وتحتار المخيلة في استحضار بعض مشاهد وصور تلك المآسي من خزانة ملح الكلمات وعسل حبر القصائد التي كنت أكتبها للحبيبة والحياة والأطفال في مستهل حياة الكتابة عندي..
وقبل أن نتعود جبرا على اعتياد تنفس روائح الموت ومشاهدة صور من المعركة مع تناولنا وجبات العشاء؟! وقبل أن تنتقل سواتر القتال وأكياس الرمل من جبهات إلى ساحات وشوارع المدن بدخول مرحلة تطور شمولي آخر في التعبير: وسائل الدفاع عن الحدود بشن حرب الصواريخ على المدن والمدارس والمباني المدنية، ليختلط موت الآباء مع الأبناء بسرعة ذلك القصف الذي غيّر ووسّع من دوائر الموت، وهي تعاكس فكرة ومحنة قصيدة لوركا قاسية الذكر!
وماذا عليّ الآن، وأنا أدور في عتمة بحار ومحيطات الذاكرة كي أدلي بشهادة مقاتل وشاعر كان قد حصل على شهادة البكالوريوس في علم النفس، فوجد نفسه تلهث بتغيير حواسها ونسيان غرائزها لمجرد كوني مقاتلا طاف كل الجبهات من الشمال إلى الجنوب، وبالعكس، حاملا رتبة “نائب عريف مهذب” يحلم بأن يبقى على قيد كتابة الشعر وحب الحياة، فالشجاعة لديه- في أحيان كثيرة- هي أن يبقى حيا ووسيما كعنقود عنب أسود، رشيقا مثل أبرة، ودافئا كالقبر** وأن مثولي مجددا أمام محنة التساؤل المضني، الذي أطلقه كاتب بلغاري مجهول الإسم عبر ملاحظة كتبت بتأريخ 23 آب/ أغسطس 1939، أي قبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب العالمية الثانية تقول:
“لقد أنتهى كل شيء… ولو كنت كاتبا حقا لتمكنت من منع وقوع الحرب”! وهذا ما أكد عندي ما كنت أؤمن به، وما أتفق عليه مع عبارة بيكاسو الرائعة: “على الحياة أن تمضي، فالحياة هي نحن”.
وحين عرفت بأن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بالموت، وأن ليس بإمكانه النظر مباشرة إلى اثنين هما الشمس والموت، أدرت بوصلتي- بشكل أوضح- صوب ربوع الأحلام وقناطر المخيلة، أبدد وحشتي في نوبات حراستي الليلية بالذكريات واستهلاك كل ما أدخرت من ترياق الأحزان: (أغاني ياس خضر.. ووووو)، كى أنسى سنوات الجامعة وحلاوة عفوية ضحكات أمونة حبيبتي قبل أن تكون زوجتي وأم طفالي في النصف الأول من أولى حروبنا اللاحقة.
كنت أتوق إلى ممرات جريدة الجمهورية، رحم احتضان أولى جنوناتي الأليفة في ملحق تموز الخاص بأدب الأطفال وقبلها في “مجلتي” و”المزمار”، من أتذكر من أحبابي؟ أصدقائي؟ من حسادي الأبرياء مثل ظنونهم حين كانوا يشبهوني بالممثل المصري أحمد زكي وبما يجعلني محببا لدى موظفات الجريدة ومنتسبي دار ثقافة الأطفال، التي كان يطلق عليها الفيلسوف والمفكر مدني صالح- تحبيبا- اسم “دائرة تسمين البلابل وتهذيب العصافير”.
من كان سيهذب أحلامي ونقاء روحي التي أكلتها الحرب في جبهات القتال والخنادق وسواتر الموت كل يوم على أرض ساخنة- ملتهبة صيف شتاء، متوسدا ضوابط وصرامة ما تفرضه حياة العسكر بطوال سنوات كابوسية أضحت دهورا في قيعان خوفي على الوطن.
** من قصيدة له بعنوان: “عشية ربع قرن أصدقائي”، من مجموعتي: “ربما نلتقي ..ربما لا”
نُشر هذا الموضوع في العدد 54 من مجلة الإنساني الصادر في ربيع/ صيف 2012، ضمن محور العدد «عزيزي الأديب: إنها الحرب.»


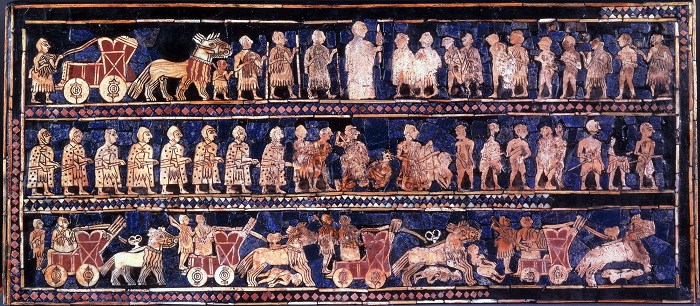


تعليقات