أنا ممرضة إسبانية، وطيلة عام كامل عملت في قطاع غزة «ممرضة غرفة الطوارئ» لدى «الصليب الأحمر البريطاني»، ثم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تمثَّلت مهمتي، ضمن فريق الرعاية الصحية، في بناء قدرات الموظفين في إدارات الطوارئ للمستشفيات الحكومية في أرجاء غزة. خلال تلك الفترة، لم أعمل بجد وحسب، وإنما عشتُ أيضًا في هذه المنطقة، وشعرتُ بها كأنها موطني. سكنت هذه المنطقة قلبي، وأصبح لها مكانة ثابتة لا تتزحزح.
في البداية وضعت عنوانًا لهذه السطور «غزة وإسبانيا .. ثقافتان مفعمتان بالحيوية مرتبطتان سويا بالحياة». قد يبدو هذا العنوان غير دقيق، إذ تُعقد فيه مقارنة بين منطقة مساحتها نحو 45 كيلو مترًا وبلدٍ كامل.
لا يزال قطاع غزة خاضعًا لحصار بري وجوي وبحري منذ العام 2007، وهذه حقيقة تجعل هذا الجزء من العالم متفردًا بشكل خاص. وهذا التفرد يسمح لي أن أعقد المقارنة بين غزة وبلدي وثقافتيهما. فصمود أهل غزة ليس وحده هو الملمح المشترك، إنما أيضًا قدرتهم على الترحيب بك، وشعورك بأنك في بيتك. وهناك أصوات الناس العالية، ولغة الجسد كما تظهر في كلام الأهالي وضحكاتهم. بإيجاز، يتشابه الغزاويون والإسبان للدرجة التي جعلتني أشعر منذ اليوم الأول من مهمتي كأنني في بيتي.

الممرضة الأسبانية إيكو باوتيستا جارسيا جالسة في قطاع غزة وخلفها جدارية مرسوم عليها علم فلسطين.
عايش سكان غزة من الشباب، وكذلك الممرضات والأطباء الشباب، نزاعات مسلحة شهدت تدفقًا كبيرًا في أعداد الضحايا على المستشفيات. وفي الحرب الأخيرة، في صيف 2014، جُرح نحو 11784 شخصًا وقُتل نحو 2275 آخرين، كما دُمرت مبان أو أُضيرت ضررًا بالغًا.
نحن الآن في العام 2017، بما يعني أننا أمضينا قرابة ثلاث سنوات من دون اندلاع نزاع مسلح كبير. ومع ذلك، يتواصل الكفاح. فالاحتياجات الأساسية لأهل غزة لم تلبَّ. الاحتياجات التي لا غنى عنها، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية، غير متاحة لأهل القطاع، وهم قرابة مليوني نسمة يعيشون في هذه المساحة المحدودة من الأرض، وتتفشى في أوساطهم البطالة بمعدل 41.7%، وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم. وتعاني نسبة 47% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي انعدامًا حادًّا.
ولا يزال قطاع الصحة الهش بالفعل يواجه صعوبات، عندما يحاول تقديم رعاية صحية جيدة. والمشكلات الرئيسة التي يواجهها الأهالي هي نقص التمويل، ونقص إمدادات الطاقة، والقيود على حرية الحركة، وإغلاق المعابر، وتأخر دفع الرواتب.
حتى مع عدم وجود قتال على نطاق واسع، يُعد وصف هذه الفترات بين الحروب بأنها «وقت السلام» مجافيًا للحقيقة. في هذه الأثناء، وعندما يصل مصاب للمستشفى يضطر الأقارب إلى البحث عن مكان له/ لها واستدعاء طبيب، وإتمام الفحوصات التي يطلبونها، وهو أمر يعتمد كلية على الموارد المحدودة للمستشفى. بعد ذلك يتنقل الأقارب بين أقسام مختلفة: أشعة إكس، ودورات المياه، ومعمل تحليل الدم وغيرها من الأقسام. أما التحكم في الألم فهو رفاهية، إذ يضطر المرضى إلى تبادل أقنعة استنشاق الأوكسجين، ويضطرون أحيانًا إلى استقلال سيارات تسير عبر طرق غير ممهدة، ومليئة بالمطبات والتعرجات، لمجرد إجراء فحص غير متاح في مستشفياتهم.
يحاول أهل غزة التغلب على محدودية الموارد. بصراحة، قد يكون من المبالغة القول «التغلب» على هذه الصعاب. فبعض المستشفيات الجراحية الرئيسة في قطاع غزة لا تقدم التصوير المقطعي بأجهزة الكمبيوتر، والمستشفيات التي توفره قد يضطر المريض فيها للانتظار شهورًا حتى ينتهي إصلاح أجهزتها، نظرًا لصعوبة الحصول على قطع الغيار وإدخالها إلى غزة. وهذا يعني أن المرضى ينتقلون إلى المستشفيات التي توفر هذه الخدمة، بينما ينتظر العاملون في الرعاية الصحية عودتهم بالأشعة.
وتأتي الأدوية والمستلزمات الطبية الاستهلاكية إلى غزة بشكل رئيس من رام الله، أو من خلال ما تقدمه المنظمات الدولية، بعد أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدخولها. وهذا يعني، مرة أخرى، أن المرضى يسمح لهم بالدخول ثم ينصرفون وهم لا يزالون يعانون الألم بسبب نقص المسكنات. ولا تستخدم أجهزة رسم مخطط كهربائية القلب من دون قيود، لئلا ينفد الورق (وكما يمكن للقارئ أن يتوقع، فهذه القيود قد تزيد من خطر عدم اكتشاف الأزمات القلبية). وتضطر المراكز الصحية إلى إدخال المرضى إلى العنابر من دون أن يحصلوا على الجرعة الأولى من المضادات الحيوية.
ولا يوجد أيضًا إمداد مستدام للطاقة، وتحتاج المولدات الكهربية إلى كميات كبيرة من الوقود، وهو ما يتطلب جهدًا هائلًا لإيجاد متبرعين. فعلى سبيل المثال، يبلغ استهلاك مستشفى الشفاء – وهو الأشد اكتظاظًا بالمرضى في غزة – 650 لترًا من الوقود في الساعة. وعندما نترجم هذه البيانات إلى واقع يعيشه الناس نجد أن جراحات معينة لا تتجاوز نسبة إجرائها الحد الأدنى نظرًا لندرة الوقود.
موظفو الرعاية الصحية أبطال حقيقيون، يمرون بالكثير من الصعاب ويواجهون تحديات كبيرة، بمرتبات مستنزفة، ويعتمدون بالأساس على المتطوعين. وهم يواجهون يوميًّا مجتمعًا غاضبًا يريد أن يتلقى العلاج بما يصون كرامة المرضى ويلبي احتياجاتهم الأساسية. وكما هو متوقع، قد تجد – وهذا أمر مفهوم – قوة عاملة ذات همة مثبطة، وأفرادًا منهكين يعزفون عن بذل أقصى ما لديهم، لكن من واقع تجربتي، فإن الغالبية العظمى من الموظفين يقاومون الصعاب في الميدان، ويبذلون كل ما بوسعهم من أجل تخفيف حدة معاناة الناس.
وفي ظل هذا الحصار طويل الأمد يدرك المرء فجأة أن الأمراض غير المعدية، مثل أمراض أوعية القلب والمخ، والسرطان، والسكري، هي الأسباب الرئيسية للوفاة في أوساط البالغين، كما تذكر منظمة الصحة العالمية. وقبل حرب العام 2014، كانت الأمراض غير المعدية مسؤولة بالفعل عن أكثر من 50% من حالات الوفيات في غزة. فإذا ما أُضيفت للمعادلة الفرص الاقتصادية القليلة للغاية، والنظام الصحي الذي يعاني من نقص مزمن في الموارد، والمجتمع الذي يرزح تحت أعباء سنوات من النزاع والحصار، فإن هذه النسبة من الوفيات لا يتوقع لها إلَّا الزيادة.
لكن ومع أن هذا الوصف الحقيقي للواقع في غزة قد يكون محبِطًا، فإن ما أحمله وأنا عائدة إلى إسبانيا هو: أنني بذلت ما بوسعي لتخفيف جزء من المعاناة التي تعصف بهذا الجزء من العالم، وأنه رغم الظروف وشحِّ الأمل، فثمة بسمة ترحب بك في تلك البقعة أينما كنت، وأنه مهما قل ما تملكه، فإنك تشرك فيه مَن حولك. لقد صارت غزة من الآن فصاعدًا وطني الثاني



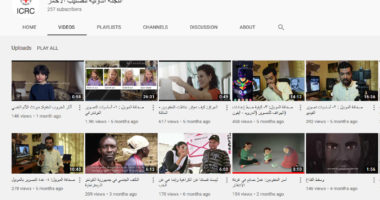

Comments