هل نحن أمام تحديات جديدة تواجه المعاهدات الإنسانية الدولية؟ إذ تعرب دول عدة علنًا عن شكوكها في إمكانية استمرارها في التقيد بمعاهدات إنسانية، ومنها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في حين دخل انسحاب ليتوانيا من الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية حيز التنفيذ في وقت سابق من آذار/مارس المنصرم، في حدث غير مسبوق. وتتواكب هذه التطورات مع تصاعد التوترات على الساحة الدولية وتزايد المخاوف الأمنية، سواء في أوروبا أو على مستوى العالم. وهي تأتي في وقت يتضاءل فيه احترام المعايير الإنسانية الأساسية إلى مستويات صادمة، وتتبدى انعكاسات هذا الوضع في حجم الدمار الهائل الناجم عن النزاعات الدائرة.
في هذا المقال، تقدم الخبيرتان البارزتان في اللجنة الدولية للصليب الأحمر – كوردولا دروغيه ومايا بريم – تحليلاً عميقاً لتداعيات هذا التحول الخطير. وتُحذران من أن التحديات الأخيرة التي تواجه اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تنبئ بتهديدات أكبر تحيق بضمانات الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في سعيه لإنقاذ الأرواح. تكشف المقالة عن الحقائق المخفية وراء مبررات استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتفند الادعاءات المتعلقة بضرورتها العسكرية، محذرتين من أن التخلي عن هذه الاتفاقيات لا يهدد فقط أرواح الأبرياء، بل يقوض أسس النظام القانوني الدولي بأكمله. ويختتم المقال بدعوة إلى تدعيم المعايير الإنسانية باعتبارها ضمانات ضرورية لصون مبدأ الإنسانية في الحروب.
على خلفية النزاع المسلح الدولي الدائر بين روسيا وأوكرانيا، ازدادت حدة المناقشات في بعض الدول بشأن إمكانية الانسحاب من المعاهدات الإنسانية التاريخية، ومنها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. وأعقبت هذه المناقشات انسحاب ليتوانيا من الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية في أيلول/سبتمبر الفائت في خطوة غير مسبوقة، والذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس الماضي. وفي خطوة غير مسبوقة أيضًا، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية خريف العام الماضي عن اعتزامها إرسال ألغام مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، فثار الجدل من جديد حول فائدة هذه الأسلحة ومقبوليتها وقانونيتها، بعد أن كان السائد أنها باتت شيئًا من الماضي.
وتقتضي حماية المدنيين وغيرهم من ضحايا الحروب، سواء في أوروبا أو خارجها، تعزيز الدوافع الإنسانية للتقيد بالمعاهدات، مثل اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، ورفض المفهوم القائل بأن احترام القانون الدولي الإنساني، مهما كانت الظروف استثنائية، قد يخضع للاعتبارات الأمنية أو الدفاعية.
التبعات الإنسانية المدمرة والممتدة لـ الألغام المضادة للأفراد
تزهق الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب القابلة للانفجار آلاف الأرواح كل عام، وتُبدد سبلَ كسب العيش. ويعاني الناجون من الألغام الأرضية، وأكثرهم من الأطفال، إصابات وصدمات تغير مجرى حياتهم، بل إن بعضهم يفقد القدرة على السير مجددًا. ففي أوكرانيا مثلاً، تعد الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار سببًا رئيسًا لسقوط الضحايا من المدنيين، لا سيما في مناطق خطوط المواجهة والأراضي التي استعيدت السيطرة عليها.
ولا تتوقف الأضرار عند هذا الحد، ففداحة التلوث لا تظهر بكامل مداها إلا بعد فترة من الزمن. فمن كمبوديا إلى كرواتيا، تربض الألغام المضادة للأفراد عقودًا بعد زرعها، مختبئة تحت الغبار والأنقاض، جاهزة لتشويه لاجئين عائدين إلى ديارهم لا يلقون بالًا لما تُخلّفه الأعمال العدائية بعد انتهائها، أو قوات حفظ السلام التي تراقب خط الفصل، أو رعاة يسوقون ماشيتهم، أو أطفال يلعبون في الهواء الطلق.
قلَّلت اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد إلى حد بعيد أعداد القتلى أو الجرحى الذين يسقطون من جراء تلك الألغام منذ دخولها حيز النفاذ قبل 26 عامًا. وأدت كذلك دورًا جوهريًا في التشجيع على تدمير مخزونات تقدَّر بالملايين من الألغام المضادة للأفراد، وتطهير مساحات شاسعة من الأراضي (أعلنت 30 دولة من الدول الأطراف التي تلوثت أراضيها بالألغام في السابق خلوها منها)، وحفزت الاهتمام بمحنة الناجين منها، وساعدت في تعبئة موارد كبيرة لتمويل الأعمال المتعلقة بالألغام.
لكن الخسائر البشرية ارتفعت ارتفاعًا مأساوياً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، سجَّل مرصد الألغام الأرضية وقوع 833 حالة بين قتيل وجريح من جراء الألغام المصنعة المضادة للأفراد وحدها، في أعلى حصيلة مسجَّلة للضحايا سنويًا منذ العام 2011. ويرى المرصد أن هذا الارتفاع يُعزى في أكثره إلى الاستخدام الواسع للألغام المضادة للأفراد في النزاع المسلح الدائر بين روسيا وأوكرانيا (وكذلك استخدامها مجددًا في إيران وميانمار وكوريا الشمالية)، واستخدام الألغام يدوية الصنع، وتُنسب معظم هذه الحالات إلى الجماعات المسلحة من غير الدول. فسُجِّل وقوع ضحايا بسبب الألغام يدوية الصنع في عام 2023 في 23 دولة، ليكون هذا النوع سببًا في وقوع أكثر الخسائر البشرية من بين أنواع الألغام/مخلفات الحرب القابلة للانفجار على مدى سنوات عدة.
ورغم تذبذب أعداد الضحايا من عام لآخر، يظل نمط الأضرار على حاله دون تغيير، وهو أمر موثَّق توثيقًا جيدًا منذ أزمة الألغام الأرضية العالمية في التسعينيات من القرن العشرين. وما يزال المدنيون – الواجب حمايتهم بالأخص من آثار الحرب – يتحملون العبء الأكبر، إذ شكلوا 84% من ضحايا الألغام/مخلفات الحرب القابلة للانفجار في 2023، وكان من بين الضحايا عديد من الأطفال.
إن الآثار الإنسانية التي تخلفها الألغام المضادة للأفراد مدمرة، لكن لا غرابة في ذلك. فهذه الأسلحة “تنفجر بفعل الضحية”، أي أن اللغم “مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو مسه له. ويؤدي هذا إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص واحد أو أكثر”، وفقًا للتعريف القانوني (المادة 2(1) من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، الذي يكاد يتطابق مع التعريف الوارد في المادة 2(3) من البروتوكول الثاني المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بصيغته المعدلة). وليس بإمكان الألغام المضادة للأفراد التمييز بين جندي وطفل، فآثارها عشوائية، ويرى البعض أنها من الأسلحة عشوائية الطابع، ما يدرجها ضمن الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني. فالالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحدُ القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي بني عليها الحظر القانوني للألغام المضادة للأفراد بموجب الاتفاقية المبرمة في عام 1997 (ديباجة اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد).
ومن المسلم به أن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تكللت بالنجاح على نطاق واسع، إذ تحظى بدعم دولي واسع، ويلتزم بها أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (164 دولة طرفًا اعتبارًا من آذار/مارس 2025)، بينما اتخذت دول أخرى و54 جماعة مسلحة من غير الدول من قواعدها سياسة تلتزم بها رسميًا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، جددت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الخامس للاتفاقية المنعقد في مدينة سيم ريب بكمبوديا، تأكيد “التزامها الراسخ” بوضع حد لويلات الألغام المضادة للأفراد.
وبالرغم من هذا الالتزام العالمي، طفت إلى السطح ادعاءات بشأن “فوائد” الألغام المضادة للأفراد في الأشهر الأخيرة. فيقترح البعض أن بعض الألغام المضادة للأفراد قد لا تخضع للحظر المفروض بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، بينما اكتسبت مبررات استخدامها وانتشارها رواجًا في أوساط معينة. .
الفائدة العسكرية المحدودة للألغام تتضاءل أمام تبعاتها الإنسانية المدمرة
تتناقض الادعاءات التي راجت مؤخرًا عن الفوائد العسكرية للألغام المضادة للأفراد في الدفاع الوطني أو الردع تناقضًا صارخًا مع الجهود التي بذلتها الدول والأطراف الفاعلة الأخرى على مدار عقود للقضاء على هذه الأسلحة، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة.
خلصت دراسة متعمقة أُجريت بتكليف من اللجنة الدولية عام 1996 – وأيَّدها ضباط عسكريون من 19 دولة، معظمهم يتمتعون بخبرة مباشرة في استخدام الألغام – إلى أن الألغام المضادة للأفراد “ذات فائدة عسكرية محدودة”، بل إن هذه الفائدة “تتضاءل كثيرًا أمام التبعات الإنسانية المروعة الناجمة عن استخدامها في حالات النزاع الفعلية”. ولم تتوصل الدراسة، التي تناولت 26 نزاعًا اندلع منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أي دليل يؤيد الادعاءات التي تزعم أن الألغام المضادة للأفراد سلاح لا غنى عنه أو ذو قيمة عسكرية مرتفعة.
وإلى جانب تبعاتها الإنسانية الهائلة التي تمتد إلى ما بعد النزاعات، توصلت الدراسة إلى ما يلي:
- يمكن اختراق حقول الألغام باستخدام معدات إزالة الألغام بسرعة نسبيًا، وأن فعالية هذه الحقول لا تثبت إلا عند توفر تغطية نيرانية لها، وأنها أخفقت عمليًا في صد التسلل العسكري؛
- إنشاء حقول الألغام ومراقبتها وصيانتها وتطهيرها مهمة تستغرق وقتًا طويلاً وعالية التكلفة وخطيرة؛
- أدى استخدام الألغام المضادة للأفراد إلى سقوط ضحايا من قوات الطرف الذي يزرعها والقوات الصديقة، وأضعف مرونتها التكتيكية كذلك.
وجدت الدراسة كذلك أن استخدام الألغام المضادة للأفراد بطريقة تتوافق مع العقيدة العسكرية التقليدية ومتطلبات القانون الدولي الإنساني (بشأن وضع العلامات ورسم الخرائط، إلخ) عملية بالغة الصعوبة في ظروف ميدان القتال – حتى بالنسبة إلى الجيوش المحترفة – ولم ينجح ذلك على الصعيد العملي إلا في أحوال نادرة. وأبرزت الدراسة أيضًا أن الألغام المضادة للأفراد التي يتم إطلاقها عن بُعد (مثل الألغام التي تنشر بواسطة المدفعية) تفرض تحديات خطيرة في تحديد مواقعها وتسجيل استخدامها، ما يثير مخاوف خاصة بشأن حماية المدنيين.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، أعادت لجنة من خبراء عسكريين رفيعي المستوى تأكيد وتحديث النتائج التي توصلت إليها الدراسة. وشددت على توفر وسائل بديلة (لمنع دخول منطقة ما، أو تطويع التضاريس، أو منع إزالة الألغام المضادة للمركبات مثلاً)، وأن الألغام المضادة للأفراد أصبحت زائدة عن الحاجة في ظل التحسينات الأساسية في الوسائل التكنولوجية العسكرية وتطور أساليب الحرب.
ومنذ ذلك الحين، تعززت هذه النتائج بفضل التحسينات التي أُدخلت على تكنولوجيا مكافحة الألغام، وبزوغ حرب الشبكة المركزية [نظام حربي يعتمد على الربط الشبكي بين جميع عناصر القوة العسكرية]. وتؤيد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قادة عسكريون، ومنهم قائد القوات المسلحة اللاتفية (كانون الثاني/يناير 2024) وقائد قوات الدفاع الإستونية (كانون الأول/ديسمبر 2024)، هذا التقييم.
اتفاقية حظر الألغام بين الألغام المضادة للأفراد والأنواع الأخرى
يجادل البعض بأن أنواعًا معينة من الألغام المضادة للأفراد ربما تخرج عن نطاق الحظر المفروض بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، أو لا تهدد المدنيين تهديدًا حقيقيًا. تشير هذه الادعاءات أحيانًا إلى تطورات غير محددة المعالم في تكنولوجيا تصنيع الألغام (الألغام “الذكية”). ويكثر الحديث هنا عما يُسمى الألغام “غير الدائمة” المضادة للأفراد، التي تتميز بخصائص إبطال وتدمير ذاتي؛ وهي آليات تدَّعي بعض الدول أنها “تقلل المخاطر الإنسانية على نحو مناسب.”
وبالرغم من اسمها، تستمر مخاطر الألغام “غير الدائمة” المضادة للأفراد طويلاً. وعند تفعيلها، تكاد آثارها العشوائية تماثل الآثار الناجمة عن أي سلاح آخر ينفجر بفعل ملامسة الضحية له. إضافةً إلى ذلك، تفشل نسبة من هذه الألغام في تدمير نفسها ذاتيًا على النحو المنشود، ومن المرجح أن تكون معدلات الفشل في ميدان القتال أعلى منها في ظروف الاختبار المحكومة بضوابط. ويمكن نشر الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بُعد بكميات كبيرة؛ فحتى لو كان معدل الفشل منخفضًا نسبيًا، يمكن أن يحدث قدراً هائلاً من التلوث. ومن المنظور الإنساني الداعي إلى إزالة الألغام، لا بد من التعامل مع الألغام المضادة للأفراد كافة – بما فيها الأنواع التي تسمى الألغام “غير الدائمة” – باعتبارها أسلحة خطرة، لأن الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنها تدوم طويلاً بعد انقضاء الغرض من استخدامها.
أما بشأن التساؤلات المتعلقة بقانونية هذه الأسلحة، تحظر الاتفاقية كافة الألغام المضادة للأفراد بدون استثناء. ولا يميز تعريف الاتفاقية للألغام المضادة للأفراد (المادة 2(1)) بين أنواع الألغام بناءً على مدة احتفاظ الجهاز بقدرته على التفعيل والانفجار بفعل الضحية. وقد حظيت مسألة الألغام “غير الدائمة” بنقاشات مستفيضة في الفترة التي سبقت تعديل البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في العام 1996، قبل اعتماد اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. ولا شك في أن المراد كان إدراج هذا النوع من الألغام ضمن نطاق الحظر الشامل الذي تفرضه الاتفاقية.
على النقيض، لا تفرض اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد حظرًا على أنواع أخرى من الألغام. فلا تسري على الألغام البحرية أو الألغام المضادة للمركبات، ومنها الألغام الميكانيكية التقليدية والألغام الحديثة “الذكية” و”الشبكية” المضادة للدبابات. ويخضع استخدام هذا النوع الأخير للبروتوكول الثاني المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 1980، والبروتوكول الثاني لعام 1996 المرفق بالاتفاقية ذاتها بصيغته المعدلة، حيثما ينطبق، وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية والألغام الأرضية (دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد من 81 إلى 83).
لا تحظر اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد كذلك الذخائر المتفجرة المتحكم بها عن بُعد، ومنها الأنواع التي يفجرها الجنود باستخدام سلك إطلاق أو ترددات لاسلكية. ويشار إلى هذه الأسلحة أحيانًا باسم “الألغام” دون تمييز، مثلما هو الحال مع “لغم كلايمور” (Claymore) الأميركي، أو “لغم الجليد” (JÄÄMIINA) الفنلندي، الذي كان له دور بارز في “حرب الشتاء” (1939-1940). لكن عند استخدام هذه الذخائر في وضع التحكم في التفجير عن بُعد، لا ينطبق عليها التعريف القانوني “للغم” بحسب المادة 2(1) من البروتوكول الثاني المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة والمادة 2(1) من البروتوكول الثاني المرفق بالاتفاقية ذاتها، بصيغته المعدلة. وعوضًا عن ذلك، يخضع استخدام هذه الذخائر للقيود المفروضة على “النبائط المتفجرة الأخرى” في البروتوكول الثاني المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 1980 والبروتوكول الثاني لعام 1996 المرفق بالاتفاقية ذاتها بصيغته المعدلة، حيثما ينطبق، وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية والأسلحة.
الحرب ليست استثناءً: اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تسري في جميع الظروف
في سياق النزاع المسلح الدائر بين روسيا وأوكرانيا، غالبًا ما تستند الحجج التي أُدلي بها مؤخرًا بشأن الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد إلى قانونية ومشروعية استخدام القوة دفاعًا عن النفس ضد العدوان الذي يشنه الخصوم. ويجادل أنصار هذا الرأي بأن استخدام الألغام المضادة للأفراد والانسحاب من الاتفاقية لهما ما يبررهما في ظل ظروف استثنائية، ويدَّعون بأن القائمين على صياغة الاتفاقية لم يتنبؤوا بهذه السيناريوهات، وأن الالتزام بقيود الاتفاقية يضع الدول في موقف ضعف عند مواجهة خصوم لا يخضعون للقيود ذاتها.
وتغالي هذه الحجج في تقدير الفوائد العسكرية والأمنية للألغام المضادة للأفراد (انظر ما سبق)، وتتجاهل المسوغات الإنسانية الداعية إلى إبرام اتفاقية حظرها. فقد كانت الاتفاقية استجابة مباشرة لتاريخ طويل وموثَّق من المعاناة الناجمة عن تلك الألغام في نزاعات مسلحة دولية وغير الدولية في مختلف أنحاء العالم. وبناءً عليه، تعهدت كل دولة طرف في الاتفاقية “بألا تقوم تحت أي ظروف” باستعمال الألغام المضادة للأفراد (ونقلها وتخزينها، إلخ) (المادة 1). ويوضح أحد المعلقين القانونيين هذا بقوله: “الظروف التي تتحدث عنها العبارة تشمل وقت السلم وأي نزاع مسلح، وتمنع ارتكاب الأعمال المحظورة بصورة شاملة في الحالتين”. ويعد استخدام الألغام المضادة للأفراد في إطار تدابير الاقتصاص الحربي عملاً غير قانوني كذلك بمقتضى الاتفاقية، بصرف النظر عن لجوء الخصم لهذه الأعمال من عدمه أو مدى صعوبة الظروف، بل يشمل ذلك حالة الدفاع عن النفس ضد العدوان.
ويؤكد الحكم المتعلق بالانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد أن القائمين على صياغتها رفضوا عمدًا الفكرة التي تجعل النزاع المسلح مبررًا للتخلي عن هذا الحظر لإنقاذ الأرواح. فالانسحاب يصبح نافذًا في واقع الأمر بعد ستة أشهر من إخطار الأمين العام للأمم المتحدة، أما إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح خلال تلك المدة، فلا يعتبر الانسحاب نافذًا قبل أن ينتهي النزاع (المادة 20(3)).
وهذه الحجج التي راجت مؤخرًا تأييدًا لاستعمال الألغام المضادة للأفراد تتحدى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. فالادعاء بضرورة دفاع الدولة عن نفسها “بأي وسيلة” يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ مفاده أن اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقًا لا تقيده قيود (المادة 35(1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف). إن الحروب في معظمها تثير تساؤلات وجودية، وبالأخص في نفوس المتضررين منها تضررًا مباشرًا. بيد أن هذه المخاوف لا تبرر التخلي عن الحماية القانونية أو الالتفاف عليها، إذ إن المقصود بها الحفاظ على سلامتهم. وبصرف النظر عن سبب اندلاع الحرب – سواء أكانت الدولة تشن حربًا عدوانية أو تدافع عن نفسها – ينطبق القانون الدولي الإنساني بالتساوي على جميع الأطراف ومهمته حماية ضحايا النزاعات المسلحة كافة، بصرف النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه.
وقد اعتُمدت اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وغيرها من القيود المفروضة على وسائل الحرب وأساليبها لصون الإنسانية في أوقات الحرب. فتصوير المسألة كما لو “إننا نقاتل وأيدينا مكبلة وراء ظهورنا” مضلِّلٌ للغاية. وحتى لو كان الخصم يتجاهل هذه القواعد، ما يزال الالتزام بالقيود الإنسانية يخدم مصالح الحكومات المعنية، ليس أقلها حماية السكان المدنيين من الأضرار.
وكما قالت رئيسة اللجنة الدولية : “لم يوضع القانون الدولي الإنساني لأيام السلم الهانئة. بل لأسوأ أيام البشر، حينما تشتد النزاعات المسلحة ويواجه الإنسان أخطارًا بالغة.”
ضرورة تدعيم المعايير الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني لصون مبدأ الإنسانية في الحروب
تثير التحديات الأخيرة التي واجهتها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد مخاوف بالغة بشأن سلامة ورفاه السكان المتضررين من الألغام. والانسحاب من الاتفاقية وانتهاكها يضعفان فعاليتها ومصداقيتها، فتتضاءل مساحة الالتزام العالمي بها، وتنحسر المعايير الإنسانية التي أرستها. وتزيد بذلك احتمالات استخدام الألغام المضادة للأفراد وانتشارها، ما يشكل تهديدًا واضحًا وملموسًا على المدنيين. ولقد برهن التاريخ أن قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية وحدها غير كافية لمنع المعاناة الإنسانية الهائلة الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد، أو التصدي لها. وفي العام 1997، اعتُبر فرض حظر قانوني شامل هو الحل الفعال الوحيد، وما يزال كذلك حتى وقتنا الحاضر.
إلا أن التبريرات التي تساق للتخلي عن الصكوك الإنسانية، والصمت على الانتهاكات وحالات الانسحاب من الاتفاقية، تشكل مخاطر أوسع على الاتفاقات الدولية لنزع السلاح ومراقبة الأسلحة، وعلى حماية ضحايا الحروب. وتترتب على السرديات التي تروج للجوء إلى أوضاع استثنائية، ازدواجيةٌ مربكة في المعايير؛ فإما أن يُتوقع من بعض الدول الوفاء بالتزاماتها بينما تتغاضى عنها دول أخرى، وإما أن تتخلى جميع الدول عن التزاماتها، ما يؤدي إلى انحسار شامل لسيادة القانون الدولي.
لا بد من تأكيد المعايير الإنسانية باستمرار. وتقع على عاتق الدول وأطراف النزاعات المسلحة، وعلى عاتقنا جميعًا في نهاية المطاف، مسؤولية نبذ اللجوء إلى وضع استثنائي، باعتباره وعدًا كاذبًا لا يحقق الأمن، والسعي بدلاً من ذلك إلى تعزيز الوصم المرتبط بالألغام المضادة للأفراد والأسلحة الأخرى التي تسبب أضرارًا غير مقبولة ودعم التنفيذ الأمين للقانون الدولي الإنساني. وإذا كانت الوثائق الختامية لاجتماعات الدول الأطراف تدل على أي شيء، فهو أن غالبية الدول ترغب في صنع مستقبل يخلو من تهديدات الألغام المضادة للأفراد. ورغم ما يعتري الصكوك الإنسانية، مثل اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، من أوجه قصور، فإنها تؤمن حماية لا غنى عنها وضمانات ضرورية لصون مبدأ الإنسانية في الحروب.
يمكنكم قراءة النسخة الانكليزية من هذا المقال على مدونة القانون الإنساني والسياسات
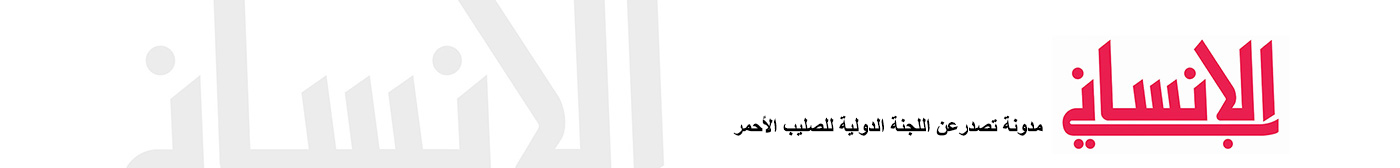






تعليقات